التمييز ضد المرأة وحقوقها.. بين الإرث الاجتماعي والتشريع الديني (3-3)
السياسية - Friday 17 May 2019 الساعة 03:02 am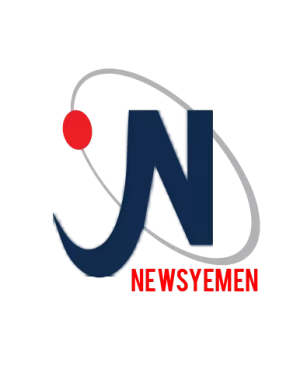 نيوزيمن، كتب/أ.د/ حمود العودي
نيوزيمن، كتب/أ.د/ حمود العودي
لمتابعة الحلقات السابقة:
التمييز ضد المرأة وحقوقها.. بين الإرث الاجتماعي والتشريع الديني (2-3)
التمييز ضد المرأة وحقوقها.. بين الإرث الاجتماعي والتشريع الديني (1-3)
قياساً عليه، وبما أن المرأة اليوم وبعد أكثر من 1400 سنة من ثبات الإسلام وعدالته بحق المرأة واستقراره في النفوس وأصبحت المرأة كفؤة للرجل في ميادين الحياة المختلفة، ديناً وعلماً وعملاً وشرعاً وقانوناً، في سياق عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي، وبفضل الإسلام قبل غيره، بما في ذلك الخِبرة والكفاءة في مجال إدارة المال والأعمال التجارية، فالأقرب إلى الصواب وإلى جوهر العلة الحقيقية للمقصد الشرعي هو أن نساوي علة الكمال والنقص البشري في شهادة الرجل بعلتها المماثلة في المرأة دون تفرقة أو تمييز، استناداً لقاعدة ربط الحكم بالعلة ودورانه معها حيث دارت وجوداً وعدماً، وهي قاعدة شرعية أصيلة ومتفق عليها، وأنَّ الخروج عن ذلك والإصرار على خلافه هو ضربٌ من العنف الاجتماعي ضد حقوق الإنسان كإنسان في شخص امرأة ومجافاة لجوهر الشرع الإسلامي الحنيف.
رابعاً: إسقاط بعض تكاليف العبادة عن المرأة هو إكراماً لها وليس نقصاً في دينها
أما ما يتعلق بالقول بنقص دين المرأة لأنها لا يجوز أن تصلي أو تصوم أثناء الحيض والنفاس ولا يلزمها القضاء في رأي معظم الفقهاء، وهي لذلك ناقصة دين في رأي المتقولين بغير هدى، فهي تخريجة أسوأ خطأً من سابقاتها، لأنَّ هذا الحكم الشرعي والإلهي الحكيم هو ميزة للمرأة في دينها وليس نقصاً في ذلك، كما يتوهم المجتهدون بغير حق أو المتأولون بغير صواب، فقد خفَّف الله عنها ذلك مقابل ما تتعرض له من آلام ومتاعب جسدية أثناء الحيض والنفاس، ونحن نعرف قصص الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى، وكيف كانوا يعاودون الإلحاح والطلب من الله عزوجل أنْ يخفف عن أتباعهم الكثير والكثير من أعباء العبادات، بمن في ذلك نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، والذي طلب من الله في رحلة الإسراء والمعراج تخفيف ما كان قد فرض على أمة محمد من الصلوات من خمسين صلاة في اليوم والليلة إلى خمس صلوات، فاستجاب الله له إكراماً له ورحمة بعباده وليس انتقاصاً في الدين.
فإسقاط فروض العبادة عن المرأة أثناء الحيض والنفاس من الصوم والصلاة هو ميزة وإكرام لها وليس حطاً من قدرها وانتقاصاً في دينها، ولأن قصر المصلي في السفر يعد رحمةً وإكراماً له وليس انتقاصاً من دينه، والفكرة الشائعة والخاطئة عن نقص دين المرأة في هذا الصدد يجب تجاوزها؛ لأنها من قبيل العنف الاجتماعي والنفسي الذي لا يقره منطق عقلي ولا شرع وضعي أو ديني.. خصوصاً وأن حالات الحيض والنفاس ليست من الحالات العرضية أو المرضية، بل هي من الصفات البيلوجية الطبيعية والمرتبطة بأهم ما يتعلق بوجود البشر واستمرارهم وهي عملية الحمل والولادة التي خصّ الله بها المرأة دون الرجل، فكيف لهذه الوظيفة البيلوجية العظيمة للمرأة الحافظة للبقاء أن تتحوَّل إلى انتقاص في دينها بقدر ما أن العكس هو الصحيح.
خامساً: ولاية المرأة حق شرعي وإنساني وحرمانها منه عنف وتمييز يخل بالدين والعدل
ولاية المرأة هي من أبرز القضايا التي ما تزال موضعَ جدلٍ عميقٍ بين من يرى فيها حقاً مهدوراً بحق ومن يرى فيها شرعاً مسطوراً بغير حق، وأول ما يستدل به غير المحقين هو التعلُّل بالقول بأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: (لا يفلح قوم تولّى أمرهم امرأة) فيما يتعلق بمحاولة إثبات عدم شرعية ولاية المرأة، فقد جاء هذا الحديث "إن صح" في سياق قصة (بوران) ابنة كسرى انو شروان ملك فارس، بعد أن انهار مُلكه وقُتل في فتنة داخلية كبيرة وأُريد تنصيب ابنته بدلاً عنه، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ونواة الدولة الإسلامية في بدايتها في المدينة، فقال حديثه ذاك ـ إن كان قد قاله ـ كناية عن نهاية ملك فارس برمَّته وليس نفياً لشرعية ولاية المرأة، ولقد بلغ الأمر بهذا الاتجاه غير المُحق إلى تبرير موقفهم بالقول بأن المرأة لا يجوز لها الولاية لأنها ناقصة عقل ودين بحُجة ما سبق تحليله عن حُكم الشهادة وإسقاط بعض التكاليف الدينية عنها.
ولو كان الأمر كذلك لما قال الرسول، عليه الصلاة والسلام، في عائشة، رضي الله عنها، وفي حديث ثابت ومتفق عليه (خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء) والتي رُوي عنها كثير من أحاديث السنة النبوية الصحيحة، فهل يعقل أن مَن نؤمر بأخذ نصف ديننا عنه من أحاديث الرسول وسنته، وعلى سبيل اليقين كإنسان مثل عائشة بنت أبي بكر أن يُقال بأنها ناقصة عقل ودين، وبالتالي لا يجوز الأخذ بولايته السياسية والقضائية؟ وولاية الدين هي أولى وأهم من ولاية السياسة والسلطة في الدنيا، بل لقد ثبت أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قد ولّى منصب الحسبة في إحدى الأسواق لامرأة لمراقبة الأسعار والأوزان والمقاييس، وهي ولاية قضائية، كما أنَّ ولاية المرأة قد ثبتت بكفاءة عالية قبل الإسلام وبعده وحتى اليوم بدءاً بملكة سبأ في اليمن وملكة تَدْمر في الشام، مروراً بالملكة أروى بنت أحمد في اليمن، وشجرة الدر في مصر، وانتهاءً برئيسة وزراء تركيا وبنقلادش وباكستان من المسلمات الفاضلات.
يؤكد ذلك قول الخالق عز وجل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (التوبة 71)، وخطاب الولاية هنا شديد الوضوح للرجال والنساء على السواء في ولاية بعضهم البعض دون تمييز، وأن كل رأي أو اجتهاد يخالف هذه الحيثيات الجوهرية من كتاب الله وسنة رسوله هو من قبيل ممارسة العنف الاجتماعي الديني بغير حق وإساءة للإسلام والمسلمين.
سادساً: القوامة وظيفة اجتماعية عامة وليست خاصية بيلوجية للرجل دون المرأة قط
يأتي مفهوم القوامة في قوله تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (سورة النساء الآية 24) فقد تم تأويل هذه الآية بما يتعارض وجوهر حكمتها وحكمها معاً، فالكثير من المتأولين يقرؤونها منقطعة المعنى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} فقط على طريقة (ويل للمصلين....) وخير المتأولين من يضيف بما فضل الله بعضهم على بعض، ويصرف معنى التفضيل هنا خطأً إلى النوع البيلوجي الفطري المتعلق بالذكورة والأنوثة، بدلاً من معناه الجوهري المتعلق بالنوع الاجتماعي المكتسب وهو الإنفاق من أموالهم الذي يكتمل به نص ومعنى الآية الكريمة وحكمها. وأن الفروق الأساسية المشمولة بحكم القوامة هي فروق النوع الاجتماعي المكتسبة والمتغيرة بين مختلف أفراد المجتمع بصفة عامة والنساء والرجال بصفة خاصة أو بين نساء ونساء وبين رجال ورجال أو فرد آخر وجماعة أخرى.
وعلة التفضيل في حكم القوامة في الآية الكريمة محمول على الرزق وامتلاك الرجال للثروة أكثر من النساء ووجوب إنفاق من يملك الثروة والرزق على من لا يملكها بنفس القدر، وحمل مبدأ القوامة كوظيفة ودور اجتماعي للرجل بالنسبة للمرأة كزوجة يستند إلى مبدأ الإنفاق عليها من ماله هو لا من مالها، وهو ما تؤكده بقية الآية الكريمة: {وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، أما الفهم والتأويل الشائع لمفهوم الولاية كحق للرجل استناداً إلى نوعهم البيلوجي كذكر فهو ما لا يمكن فهمه إلا باعتباره خروجاً عن المقصد الشرعي الجوهري للآية الكريمة ونزعة لممارسة العنف الاجتماعي ليس ضد المرأة فقط بل وضد المجتمع بشكل عام.
فالقوامة ليست قط مفهوماً بيلوجياً يتعلق بالزوجة كأنثى والزوج كذكر، بل هي عقد اجتماعي يهدف إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير في حياة المجتمع ككل سواءً كان بين رجل وامرأة، أو سيد وعبد، أو عامل ورب عمل، أو حاكم ومحكوم (كُلكم راعٍ وكُلكم مسئول عن رعيته).
وهذا العقد هو نتيجة مشروطة بمقدماتها ويدور معها حيث دارت وجوداً وعدماً، وكما أن الحاكم يمكن أن يصبح محكوماً والعبد سيداً أو العامل رب عمل، وتصبح لهم قوامة على الغير بدلاً من قوامة الغير عليهم، فإن المرأة أوالزوجة يمكنها أن تصبح قيِّمة على الأسرة بمن فيها الزوج إذا كان في عُسرة وهي في يسر، وإذا كان سفيهاً وهي عاقلة سويّة، فالقوامة هي عن يقين وظيفة ودور اجتماعي، وتتسع باتساع حدود المسئولية وتضيق بضيقها، فرجل المرور قيّم على حركة سير السيارات في الطريق العام وعلى الكل أن يحترم قوامته بحكم مسئوليته بصرف النظر عمن هو الذي يسير على هذا الطريق بدءاً من رئيس الدولة في مجتمع متحضِّر وحتى أبسط إنسان عادي يمشي على قدميه، وكذلك الأستاذ على تلاميذه ورب العمل على عماله... إلخ، وبهذا المعنى الجوهري السمح والعقل المستنير ينبغي أن نفهم ديننا وشريعتنا وحكمتها البالغة، لا بتأولات وتقوُّلات عميان البصر والبصيرة وبحسن نية أو الحاقدين على هذا الموروث العظيم المتعلق بحقوق المرأة خاصة وحقوق الإنسان عامة في الشرع الإسلامي الحنيف من غير المسلمين المتعصبين بغير حق، والذين يحوِّلون دين الله وشريعته السمحة من رحمة للعالمين إلى عنف وسيف مسلط على حقوقهم ورقابهم بغير حق.
سابعاً: عنف ما تبقى من الجاهلية
وفي مقابل ما لوحظ من إيجابيات واضحة ومهمة في المرجعية الفقهية والتشريعية الإسلامية الأصيلة في البنود السابقة سنلاحظ ما هو بخلاف ذلك إلى هذا الحد أو ذاك فيما يتعلق بمرجعية التفكير السياسي والاجتماعي التقليدي المتخلّف تجاه حقوق وواجبات النوع الاجتماعي المتعلق بالمرأة والمجتمع بشكل عام، والتي نجد الكثير منها في شكل اجتهادات وتخريجات تشريعية مصطنعة ذات أبعاد سياسية واجتماعية متخلّفة، ولا تمت إلى جوهر التشريع الفقهي والإسلامي الأصيل والمتطوِّر بصِلة، وليس من ذلك ما سبقت إليه الإشارة من قضايا الإرث والشهادة والولاية والقوامة... وغيرها، وأن النساء (ناقصات عقل ودين وميراث)، بل ونضيف هنا ما هو أسوأ من ذلك وما لا يمكن وصفه إلا باعتباره بقية من جاهلية، ومن ذلك القول، مثلاً، بأن «المرأة لا ينبغي أن تعمل خارج المنزل بل ولا تخرج منه إلا مرتين في حياتها كلها: الأولى، خروجها يوم زواجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها. والثانية، خروجها يوم موتها من بيت زوجها إلى المقبرة. وأن المرأة عورة ينبغي إخفاؤها ليس فيما يتعلق بما قد يظهر من جسمها فحسب، بل وحتى صوتها وحركتها، بل ووجودها نفسه في المكان الذي يحضره الرجال، وأن الإذن بالخروج من المنزل هو واجب عليها فقط دون الرجل. ووجوب عدم سفر المرأة أو تحركها خارج المنزل عند الضرورة إلا بمحرم... إلى غير ذلك مما لا يتسع المجال لسرده».
والإنسان العاقل والمسلم المُتفقّه الحق لا يستطيع أن يرى في كل ذلك سوى تقولات وتأويلات غير صائبة في أحسن الأحوال أو تخرصات رجعية ومتخلفة ومقصودة أو غير مقصودة إن لم تكن بقية من جاهلية حقيقية، مع الأسف، تسيء إلى ديننا وتشريعاتنا الإسلامية السمحة التي ما نالت المرأة من حقوقها كإنسان في أيّ شريعة أخرى كما نالتها من خلال الشريعة الإسلامية.

